نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
علاء الدين سليم يفتح جراح النسيان في فيلمه "أقورا", اليوم السبت 12 أبريل 2025 11:47 صباحاً
نشر في باب نات يوم 12 - 04 - 2025
منذ عرض فيلمه "آخر واحد فينا" سنة 2016 ثم "طلامس" (2019) وعلاء الدين سليم يرسّخ نفسه كصوت سينمائي تونسي متفرّد ومولع بالتجريب ومنشغل بالهوامش وبالكائنات المعزولة التي تمشي على تخوم الوجود.
في فيلمه الجديد "أقورا" (إنتاج تونسي سعودي فرنسي مشترك 2024)، وهو عمل روائي طويل، يعمّق المخرج هذا المشروع الجمالي ويذهب فيه إلى أقصى مدى من العبث والغموض والرؤية النقدية عبر سرد فني يجمع بين البوليسي والفلسفي والأسطوري في آن واحد. وقد تمّ تقديم "أقورا" مساء الجمعة بقاعة سينما الريو بتونس العاصمة بحضور فريق الفيلم، علما أن العرض سيكون متاحا في القاعات للجمهور ابتداءً من يوم 16 أفريل الحالي.
يبدأ الفيلم من فرضية بوليسية تتمثل في ثلاثة أشخاص يفترض أنهم ماتوا منذ سنوات، لكنهم يعودون فجأة إلى مدينتهم الصغيرة في ظروف غامضة. وفي الفيلم لا يهتم المخرج بالتحقيق بقدر ما يهتم بخلخلة الأحداث وخلق أجواء من التوتر والاضطراب. وهؤلاء "الراجعون" جعلهم علاء الدين سليم لا ليجيبوا عن سر عودتهم المفاجئة وإنما ليزيدوا الأسئلة كثافة، فهم لا يتكلمون كثيرا ولا يطالبون بشيء، حتى إن وجودهم في حد ذاته هو الاتهام، فهم ماض لا يموت وذاكرة لا يمكن دفنها.
وهذا المنطلق البسيط نسبيا للفيلم سرعان ما يحوّله المخرج إلى بنية معقدة يتداخل فيها الزمان والمكان والحلم والواقع والعلم والخرافة والسياسة والدين لتصير المدينة كلها مسرححا لاختبار جماعي لهوية مشروخة ماضيها مُرّ وحاضرها مختنق بالصمت والنكران والنسيان الجمعي والانفصال المؤلم بين السلطة والشعب. ولذلك جاء عنوان الفيلم "أقورا" محملا بالتناقضات، فالأقورا هنا لم يكن يحمل معنى تلك الساحة العامة عند الإغريق حيث تجمع الناس وتُعقد الاجتماعات العامة بل كان رمزا للانفصال وانعدام الحوار بين السلطة (السياسية والدينية) وعامة الشعب من الكادحين والمهمشين.
ويتقمص الأدوار الرئيسية في الفيلم الممثل ناجي القنواتي في دور المحقق الأمني وهو رجل بدا يائسا أكثر منه صارما إذ يتعامل مع عودة "الراجعين" كحالة شاذة يريد احتوائها. ويرافقه صديقه الطبيب الذي جسده الممثل بلال سلاطنية وهو الذي بدا أكثر إنسانية لكنه لا يقل ارتباكا. وحين تعجز السلطات المحلية عن السيطرة على الموقف، يتم إرسال محقق من العاصمة هو الممثل مجد مستورة الذي ظهر في ثوب شاب عصري محنّك لا يخلو من الكاريزما، فيبدأ مهمته بثقة زائفة سرعان ما تتحطم أمام لا منطقية ما يحدث. وبدلا من أن يطمئن سكان المدينة يزيد من اضطرابها إلى أن تصل طبيبة سامية تجسدها سنية زرق عيونه في محاولة يائسة لإعادة النظام أو بالأحرى فرض رواية رسمية تقفل الملف، لكن الجميع يضيع، فالفيلم لا يقدّم حلولا ولا يطرح نهاية. بل يكشف أن كل شخصية مهما بدت عقلانية أو قوية تحمل بداخلها خوفا دفينا من مواجهة الحقيقة.
وليس الخيال في فيلم "أقورا" هروبا من الواقع، بل هو وسيلة لفهمه. وقد وظف علاء الدين سليم عناصر من السرد الفانتازي والميتافيزيقي ليخلق واقعا تتداخل فيه العوالم حيث تتكلم الحيوانات وتُمحى الحدود بين الحياة والموت. فالكلبة الزرقاء والغراب الأسود ليسا مجرد أدوات رمزية وإنما هما أصوات من خارج المنظومة البشرية وشهود على العبث الإنساني المستمر الذي تتكرر فيه الأخطاء نفسها تحت شعارات دينية أو سياسية قومية أو بيروقراطية.
واشتغل المخرج في "أقورا" على مسألة الذاكرة الجماعية في المجتمع التونسي وحتى العربي حيث لا تزال هذه المجتمعات تعاني من آثار العنف السياسي والقمع والانتهاكات والإفلات من العقاب. وتمثّل الذاكرة الجماعية تهديدا حقيقيا للسلطة. ويفضح الفيلم آلية الإنكار والصمت والمضي قُدُما دون مساءلة أو عدالة. فالشخصات العائدة من الموت في الفيلم هي جراح ما تزال مفتوحة، فهناك امرأة قضت أثناء محاولة هجرة غير نظامية وشخصية أخرى ضحية تفجير إرهابي وعامل مفقود في منجم. كلها شخصيات مستوحات من حالات حقيقية لم تُفتح ملفاتها. وقد كانت عودة هذه الشخصيات مروّعة للناس لأن لا أحد منهم يريد مواجهة حقيقة موتها.
وفي أحد أقوى أبعاد الفيلم، يعالج علاء الدين سليم العلاقة الملتبسة بين السلطة السياسية والدينية، حيث يُظهر كيف تتآمر المؤسستان على طمس الحقيقة تحت ذريعة "المصلحة العامة" أو "الاستقرار". ويظهر رجل الدين الذي جسده الممثل نعمان حمدة في الفيلم كشخص عاجز ومتواطئ، في حين تتصرّف السلطة السياسية ككائن بيروقراطي أعمى لا يسعى لفهم ما يحدث بل لاحتوائه ثم دفنه مجددا.
وينتمي فيلم "أقورا" إلى نفس النسق الجمالي الذي صاغه علاء الدين سليم في أفلامه السابقة، لكنه بدا أكثر نضجا وأكثر تشظيا في الآن نفسه. وقد تميز الفيلم بحركة بطيئة للكاميرا ولقطات طويلة وجاء الحوار مقتصد والإيقاع أقرب إلى التأمل منه إلى التشويق. لكن هذا البطء وظّفه المخرج بإتقان ليجعل المتفرج يعيش حالات التوتر والغموض كما الشخصيات دون أن يمنحه لحظة ارتياح.
وفي لحظات الجنون الإنساني، بدت الحيوانات (الكلبة والغراب) أكثر عقلانية من البشر. واختار المخرج إنهاء فيلمه بمغادرة الكلبة والغراب نحو مكان آخر أكثر هدوء حيث وضع الكلبة جراءها، وكأن المخرج جعل من مغادرة هذيْن الحيوانيْن الشاهدين على عبث الإنسان وموته الرمزي، انسحابا للوعي وانسحابا للتاريخ من مكان لم يعد يستحق البقاء فيه. فهذه المدينة كرمز للدولة والمجتمع تتحوّل إلى فضاء مسموم لا يتيح الحياة لا للبشر ولا حتى للحيوانات الرمزية.
وفي ختام الفيلم، حوّل المخرج الكلبة من مجرد شاهدة على الأحداث إلى أم أي أنها تنقل ما رأته إلى الجيل القادم وإن كان في مكان آخر. وهنا يكمن البعد الأخلاقي للفيلم والمتمثل في أن الذاكرة يجب أن تُنقل حتى وإن لم تُسمع وأن بعض الذاكرة قد تبحث عن مكان يمكن أن تُنبت فيه دون أن تُقتل.
.



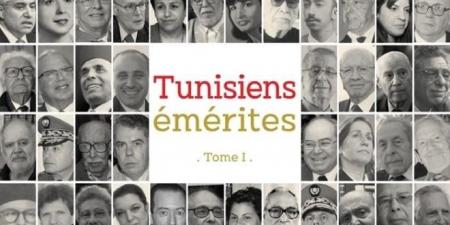
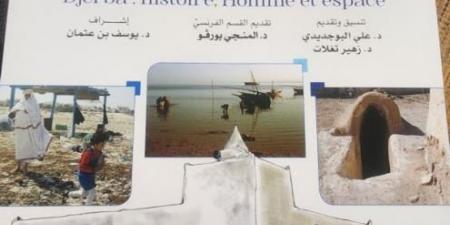




0 تعليق